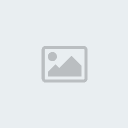٣. التجارب الداخلية
"لا يقل أحد إذا جُرِّب إني أُجَرَّب من قِبَل الله،
لأن الله غير مُجرِّب بالشرور،
وهو لا يُجرِّب أحدًا" ]13[.
بحثت الفلسفات كثيرًا عن مصدر الشر، فنادى البعض بوجود إلهَيْن، أحدهما علة الخير والآخر علة الشر... وآخرون نادوا أن الله علة الخير والشر.
والشر هنا لا يعني ما قد يحل بنا من تجارب أو كوارث أو ضيقات، بل الخطيّة والظلمة. الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة الله كلّي الصلاح الذي فيه كمال مطلق. وهنا يقطع الرسول بأن الله غير مُجرِّب بالشرور وبالتالي لا يُجَرِّب أحدًا.
حقًا قيل عن الله إنه يجلب شرًا، وهذا كقول القديس أغسطينوس من قبيل حب الله أن يحدثنا بلغتنا قدر فهمنا، فهو يجلب التأديب الذي نسميه شرًا لخيرنا. أما الشر أي الخطيّة، فلا يحرضنا الله عليها، بل ولم يخلق فينا عواطف أو دوافع أو طبيعة شريرة، بل كل ما خلقه فينا هو حسن جدًا. ونحن بإرادتنا في شخص آدم انحرفنا عما هو حسن لنشبعه بما هو ليس حسن. فالحواس والعواطف والدوافع كلها بلا استثناء يمكن أن تًوجه كطاقات للخير متى سلمت في يد الله، وكطاقات للشر متى نُزِعَت عنا نعمته...
إذن الله لا يجربنا بالشرور، إنما يسمح لنا بالتجارب الخارجيّة لامتحاننا.
يقول البابا ديونيسيوس الإسكندري:
[ربما تقول: ما هو الفرق بين كون الإنسان يُجَرَّب، وبين سقوطه في تجربة أو دخوله فيها؟ حسنًا متى انهزم إنسان بالشر، ساقطًا بسبب عدم جهاده دون أن يصونه الله بدرعه، نقول أنه دخل في تجربة وسقط فيها وصار أسيرًا تحتها. أما من يثبت ويحتمل فهذا الإنسان يكون مجرَّبًا وليس داخلاً في تجربة أو ساقطًا فيها.
هكذا اقتاد الروح السيد المسيح لا ليدخله في تجربة بل ليجربه الشيطان (مت ٤: ١).
إبراهيم أيضًا لم يُدخله الله في تجربة بل جربه...
والرب جرب (امتحن) تلاميذه...
هكذا عندما يجربنا الشرير يجذبنا إلى الشر لأنه "مُجرِّب بالشرور". أما الله فعندما يجربنا (يمتحنا) يسمح لنا بالتجارب بكونه غير مُجَرِّب بالشرور.
الشيطان يجذبنا بالقوة بقصد إهلاكنا، والله يقودنا بيده ويدربنا لأجل خلاصنا. [
إذن الشر ليس مصدره الله. فلماذا نسقط في الشر؟
"لكن كل واحد يُجَرِّب إذا انجذب وانخدع من شهوته.
ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطيّة،
والخطيّة إذا كملت تنتج موتًا" ]14-15[.
ا. الانجذاب والانخداع: يقوم عدو الخير بإثارتنا بمثيرات داخلية وخارجيّة كثيرة بلا حصر، من لذات جسديّة وملذات العالم وكراماته وأحزانه. هذه المثيرات مهما اشتدت ليست لها قوة الإلزام بل الخداع لكي ما يخرج الإنسان من حصانة الله، ويفلت من بين يديه، منجذبًا ومنخدعًا وجاريًا وراء الخطيّة.
يؤكد ربنا يسوع المسيح قائلاً: "خرافي تسمع صوتي... ولا يخطفها أحد من يدي" (يو 10: 27-2، أي لا توجد قوة مهما بلغت يمكن أن تخطف نفس المؤمن الذي يسمع لصوت الرب ويتبعه، أما إن امتنع المؤمن عن الاستماع لصوت الرب وقَبِلَ باختياره الإنصات إلى صوتٍ آخر، للحال ينخدع وينجذب من دائرة الرب إلى دائرة الخطيّة.
من يُقبِل إلى الرب لا يخرجه خارجًا (يو 6: ٣٧)، إذ هو الباب إن دخل به أحد يخلص ويجد مرعى (يو ١٠: ٩)، ولكن إن شاء الخروج عن الرب، فلا يلزمه الرب بالبقاء، عندئذ ينطلق من عناية الله تجاه خداعات العدو.
ب. الحبل: يُشبِّه الرسول الشهوات بامرأة زانية تجذب إليها الإنسان وتخدعه. وإذ يقبلها ويتجاوب معها يتحد بها فتحبل. "ثم الشهوة إذا حبلت..." أي تكون كالجنين الذي ينمو يومًا فيومًا، الذي هو الخطيّة.
ج. الولادة: وإذ يكتمل نمو الجنين تلد ابنًا هو "الموت"، لأن الخطيّة تحمل في طياتها جرثومة الموت.
تحدَّث كثير من الآباء عن هذه المراحل الثلاث. فيطالبوننا أن نصارع الخطيّة في طورها الأول وهي تحاول أن تخدع حيث لا سلطان لها علينا، ويمكننا برشم علامة الصليب وبصرخة خفيفة داخليّة تجاه الرب أن نتخلص منها. أما إذا تركنا الخطيّة لتتعدى الطور الأول إلى الثاني حيث نقبلها ونرضيها. فإن إرضاءنا لها- مهما كان إغراؤها- هو بإرادتنا ونحن مسئولون عنه.
هذا ما يؤكده القديس مرقس الناسك قائلاً يأنه لا يمكن أن تسيطر علينا خطيّة فجأة، لكن إما أننا سبق أن قبلناها بإرادتنا، أو قبلنا خطيّة مشابهة لها أو باعثة لها. فمثلاً لا تسيطر أفكار شهوة على إنسان عفوًا، اللهم إلاَّ إذا كان قد سبق أن ترك لأفكاره العنان بإرادته يتلذذ بها، أو سقط بإرادته في الكبرياء والعجرفة وحب الظهور الذي يُوَلِّد السقوط، أو سقط في الغضب بإرادته حيث تنزع عنه نعمة الله، أو أتخم معدته وتلذذ بالنَّهم.
إذن يليق بنا أن ندرك مراحل الخطيّة الثلاث (الانجذاب لها، التلذذ بها، تنفيذها) حتى نحاربها بالرب يسوع منذ بدايتها. وهذا أكثر أمانًا لنا. وقد تحدث القديس أغسطينوسعن هذه المراحل الثلاث فقال:
[الخطية تكمل على ثلاث مراحل:
ا. إثارتها (الانجذاب لها والانخداع بها).
ب. التلذذ بها (الحبل بها).
ج. إرضاؤها (الولادة).
تحدت الإثارة عن طريق الذاكرة أو الحواس كالنظر أو السمع أو الشم أو التذوق أو اللمس. فإن نتج عن هذا لذة لزم ضبطها. فلو كنا صائمين، فبرؤيتنا الطعام تثور شهوة التذوق، هذه الشهوة تنتج لذة. فعلينا ألاَّ نرضيها بل نضبطها إن كان لعقلنا - الذي يمنعنا من إرضائها - السيادة. أما إذا أرضيناها فستكون الخطيّة قد كملت في القلب فيعلم بها الله ولو لم يعلم بها البشر.
إذن هذه هي خطوات الخطيّة: تتسلل الإثارة بواسطة الحواس الجسدانيّة كما تسللت الحيّة في إثارة حواء، لأنه حيث تسربت الأفكار والتصورات الخاطئة إلى نفوسنا تكون هذه نابعة من الخارج من الحواس الجسديّة. وإن أدركت الروح أي إحساس خفي عن غير طريق هذه الحواس الجسديّة، كان هذا الإحساس مؤقتًا وزائلاً، فتسلل هذه التصورات إلى الفكر في دهاء الحيّة...
وكما أن للخطيّة مراحل ثلاث أي الإثارة واللذة والإرضاء، هكذا تنقسم الخطيّة إلى ثلاثة أنواع:
ا. خطيّة القلب (لم تنفذ عمليًا).
ب. خطيّة بالعمل.
ج. خطيّة كعادة.
وهذه الأصناف الثلاثة تشبه ثلاثة أموات:
ا. الميت الأول كما لو كان في المنزل ولم يُحْمَل بعد، وذلك عند إرضاء الشهوة في القلب (وهو صبية صغيرة).
ب. الميت الثاني كما لو كان قد حُمِل خارج المنزل، وذلك عندما يبلغ الرضا حد التنفيذ (وهو شاب أكبر من الصبية).
ج. الميت الثالث كما لو كان في القبر قد أنتن، وذلك عندما تكون الخطيّة قد بلغت حد العادة (وهو رجل أكبر من الشاب).
ونرى في الإنجيل أن الرب أقام هذه الأنواع الثلاثة من الأموات مستخدمًا عبارات مختلفة عند إقامتهم. ففي الحالة الأولى قال: "طليثا قومي" (مر ٥: 41). وفي الثانية: "أيها الشاب لك أقول قم" (لو٧: ١٤). وأما في الثالثة فقد انزعج بالروح وبكى وبعد ذلك صرخ بصوت عظيم "لعازر هلم خارجًا" (يو ١١: ٣3-4٤).]
٤. الله أبونا، لا يهب إلاَّ الصلاح
"لا تضلوا يا إخوتي الأحباء .
كل عطيّة صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق
نازلة من عند أبي الأنوار" ]16-١٧[.
في كل مرة نصلي نقول: "فلنشكر صانع الخيرات..." لأننا لا نعرف مصدرًا للخيرات غير الله. وهنا يحذرنا الرسول ألاَّ نضل، فنظن أنه يمكن أن يصدر عن الله غير الخير والصلاح، أو نحسب أننا نقدر أن ننال صلاحًا بطريق آخر غير الله. نَسَبُ الشر إلى الله ضلال، لأن الله "أب الأنوار". وطلب الصلاح من غير الله ضلال، لأنه هو "أب" لا يقبل أن يلتجىء أولاده إلى أب غيره!
إذن كل عطيّة صالحة أي لخيرنا، وكل موهبة تامة مُقدَّمة كهبة مجانيّة ليس فيها عيب أو نقصان هي من فوق نازلة، أي يوجد فيض مستمر من السماء تجاه البشر، من الأب نحو أولاده.
يقول الأب شيريمون: [يبدأ الله معنا ما هو صالح، ويستمر معنا فيه، ويكمله معنا. وذلك كقول الرسول "والذي يُقدِّم بذارًا للزارع وخبزًا للأكل سيقدم ويُكَثِّر بذاركم ويُنْمِي غلات برّكم" (٢ كو ٩: ١٠). هذا كله من أجلنا نحن، لكي بتواضع نتبع يومًا فيومًا نعمة الله التي تجذبنا. أما إذا قاوْمنا نعمته برقبة غليظة وآذان غير مختونة (أع ٧: ٥١)، فإننا نستحق كلمات النبي إرميا القائل "هل يسقطون ولا يقومون؟ أو يرتد أحد ولا يرجع؟ فلماذا ارتد هذا الشعب في أورشليم ارتدادًا دائمًا، تمسكوا بالمكر، أبوا أن يرجعوا؟" (إر ٨: 4-5).]
ويؤكد الرسول أنها من عند "أبي الأنوار. الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران".
وكما يُدْعَى إبليس أب الأشرار (يو ٨: ٤٤)، يُدْعَى الله "أب الأنوار" أي القديسين النوارنيين أو الملائكة. إنه النور الحقيقي وواهب النور. إنه ليس كالشمس المنظورة التي تعكس نورها على الكواكب الأخرى، لكنها تتغير ويأتي اليوم الذي فيه تزول، إنما هو شمس البرّ الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران!
أب ينير أولاده، وأبوته المنيرة ثابتة لا تتناقص، يجذب أولاده ليستنيروا منه. كيف يتم ذلك؟ خلال أشعة محبته المعلنة في عطاياه الزمنيّة والروحيّة يجذب أنظارنا وينير عقولنا، فنراه ونعشقه، وعندئذ لا ننشغل حتى بعطاياه الصالحة ومواهبه التامة، إنما نقول له مع القديس أغسطينوس: [قبل هذه الأعمال الجسديّة أعمالك الروحيّة التي هي سماوية ومتلألئة هكذا... لكنني جُعْتُ إليك، وعشطتُ لك... لك أنت بذاتك أيها الحق "الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران".]
عطيّة واحدة خلال كل عطاياه التي بلا حصر ومواهبه التامة يلزم ألاَّ تفارق ذهننا أبدًا، وهي عطيّة الميلاد الجديد الذي نلناه بالمعموديّة، فصرنا له أولادًا وهو أب لنا، إذ:
"شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه" ]١٨[.
يا لها أشرف عطيّة أننا بالرب يسوع "كلمة الحق" الذي مات عنا بالجسد وقام وهبنا بروحه القدوس أن نولد لله والكنيسة ولادة جديدة روحيّة بالمعموديّة.
بهذه الولادة يجدر بنا أن نرتبط بالرب يسوع "البكر"، فنصير نحن أيضًا "باكورة من خلائقه".
وكما كان الله يُلزِم عابديه أن يقدموا له البكور وأوائل الثمار مخصصة له، معتبرًا أنهم بذلك قدموا كل الثمار له. هكذا يقبلنا الله كباكورة من خلائقه، محفوظين ومخصصين لله (عب ١٢: 2٣)، وبهذا نرتبط بكنيسة الأبكار مكتوبين في السماوات.
هكذا انتقل بنا يعقوب الرسول الحديث عن التجارب الخارجيّة كمصدر فرح وتطويب للصابرين إلى الجهاد ضد التجارب الداخليّة، أي التحفظ من الخطيّة، ثم عناية الله بنا وتقديم كل إمكانية لنا، معلنًا حبه فيما وهبنا إياه أن نكون أولادًا له. لكن ما موقفنا نحن كأولاد لله؟ هذا يحدثنا عنه الرسول بطريقة عمليّة.
٥. موقفنا كأولاد لله
أولاً: الإسراع في الاستماع
"إذًا يا إخوتي الأحباء.
ليكن كل إنسان مسرعًا في الاستماع" ]١٩[.
يترجم البعض عبارة "إذًا يا إخوتي الأحباء" "أنتم تعرفون هذا. ولكن يا إخوتي الأحباء..." كأن ما قد سبق أن تحدث به هو أمر يعرفه المؤمنون، كتبه الرسول من أجل التذكرة فقط، وإنما يطلب أن نََتَنَبَّه إلى واجبنا العملي والتزامنا كأولاد لله.
وأول واجب نلتزم به هو أننا إذ ولدنا بكلمة الحق بالمعموديّة يليق بنا ألاَّ نفارق "كلمة الحق" بل نسرع دومًا للجلوس عند أقدام ربنا يسوع "كلمة الحق" مع مريم أخت لعازر، مُنْصِتين إلى حديثه العذب المملوء حبًا.
هذا هو واجبنا، وهذا أيضًا هو حقنا، وهذا هو نصيبنا الذي لن يُنْزَع منا إلى الأبد، أن نجلس متواضعين عند أقدام الرب يناجينا ونناجيه. حقًا ما أصعب على الإنسان في وسط دوامة هذه الحياة، أن يهرب! يهرب من أجل نفسه التي هي أغلى ما عنده، لكي يخلع عنه كل اهتمام واضطراب مُنصِتًا بكل جوارحه لعريس نفسه، هذا الذي يبعث صوته في داخل النفس سرورًا وفرحًا وتبتهج عظام الإنسان في تواضع وانسحاق وليس في كبرياء وعجرفة.
ثانيًا: مبطئًا في التكلم
إذ يسرع الإنسان للإنصات إلى كلمة الحق يتشرب بروح أبيه الذي لا يشهد للحق بكثرة الكلام بل بالعمل. وبهذا نتفهم الوصيّة "فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السموات" (مت ٥: 16). حسن للإنسان أن يشهد للحق، لكن كثرة الكلام والتسرع فيه يكشفان عن نفسٍ خائرة ضعيفة تخفي ضعفها وراء المظهر، من أجل هذا يوصي الحكيم قائلاً "أرأيت إنسانًا عجولاً في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به" (أم ٢٩: ٢٠).
ويقول القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك: [كثيرًا ما تكلمت وندمت وأما عن الصمت فما ندمت قط.]
وكشف لنا مار إسحق مفهوم الصمت أنه ليس مجرد امتناع عن الكلام بل هو حديث سري مع الرب يسوع، لذلك نصح الراغب في الصمت أن يقتني ثلاث خصال: خوف الله، صلاة دائمة، عدم انشغال القلب بأي أمر.
كما يقول أيضًا: [من يريد أن يلازم السكوت من غير أن يقطع علل الآلام فهو أعمى.]
إذن كما يقول الكتاب "للسكوت وقت وللتكلم وقت" (جا ٣: ٧). بوجد ثلاثة أنواع للسكوت وثلاثة أنواع للكلام:
1. الصمت المقدس، وهو أن يصمت الفم ليتكلم القلب مع الله.
2. الصمت الباطل، وهو أن يصمت الفم دون أن ينشغل القلب بالله.
3. الصمت الشرير، وهو أن يصمت الفم وينشغل الداخل بالشر.
1. الكلام المقدس: وهو الحديث الذي يقول عنه القديس باسيليوس الكبير: [يُظهر رائحة بخور تدبيرنا الداخلي المملوءة حكمة.] أي يتكلم الإنسان فيما هو لبنيان نفسه وبنيان الآخرين.
2. الكلام الباطل: وهو الحديث الذي ليس للبنيان وبلا معنى، وهذا نعطي عنه حسابًا (مت ١٢: ٣٦).
3. الكلام الشرير: الذي يهدم النفس ويهدم الآخرين.
من أجل هذا يقول الأب بيمين: [إن الصمت من أجل الله جيد، كما أن الكلام من أجل الله جيد.]